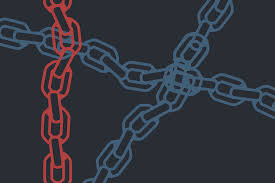في الخجل من كون المرء إنسانًا/ ماهر مسعود

في روايته المعنونة “إذا كان هذا إنسانًا“، يبدأ الروائي الإيطالي/ اليهودي بريمو ليفي، وهو الناجي من المعتقلات النازية في أوشيفيتز، بعد قضائه عامًا كاملًا هناك، قبل تحريره مع سقوط النازية عام 1945، يبدأ روايته بالكلمات التالية:
“يا من تعيشون آمنين في بيوتكم الدافئة، يا من تجدون الطعام والوجوه الصديقة، عندما تعودون في المساء، تخيّلوا إنسانًا يعمل في الطين ولا يعرف السلام، ويكافح من أجل نصف رغيف من الخبز، ويموت من أجل كلمة نعم أو لا. تخيلوا أن هذا الإنسان امرأة، بلا شعر وبلا اسم، وبلا قدرة على التذكر، أعين خاوية وحضن بارد، مثل ضفدعة في الشتاء. تخيلوا أن هذا حدث، آمركم بهذه الكلمات، احفروها في قلوبكم، وأنتم في البيت أو سائرون في الطريق، وأنتم سائرون إلى النوم أو تستيقظون، وكرروها لأبنائكم، أو لينهَر بيتكم، وليمنعكم المرض، وليشُح أولادكم بوجوههم عنكم”[1].
مات ليفي منتحرًا عام 1987، وبقيت روايته التي كتبها، كسيرة ذاتية لتجربته في المعتقل، شاهدًا فنيًا على القبح الإنساني، ليس قبح النازية وحدها؛ فالإدانة، كما نرى مثالها في سطور المقدمة، لم تكن مخصوصة بفئة محددة من الناس، بل موجهة إلى الإنسان بالمطلق، إلى البشر في كل زمان ومكان، إلى الجميع وإلى لا أحد في الوقت ذاته، هي تذكير للناس بطريقة آمرة “آمركم بهذه الكلمات”، لكنه أمرٌ يتسرّب منه الرجاء ويفيض بالخذلان واليأس، وما زال يقاوم بالكلمات، الشيء الذي يظهر الفن/ الأدب كمقاومة للقبح الإنساني، عبر ذلك الجانب الذي يخاطب الجميع، بناء على أن ما يحصل لشخص واحد يحصل له بوصفه إنسانًا، وقد يمكن لأي منّا أن يكون محله من دون أن يتغير معنى التجربة ذاتها التي تسحق الكرامة الإنسانية، وتجعل المرء يخجل من كونه إنسانًا.
يعرف سوريّو المعتقلات، وسوريّو المخيمات الغارقة في الطين والبرد والجوع اليوم، ما تحدّث عنه ليفي بشكل دقيق، وفي قلب كل واحد منهم تنمو تلك الإدانة الوجودية التي لا تعرف أين تتجه ومن تدين أولًا، فجميعنا مشاركون بما حدث ويحدث، وجميعنا مسؤولون عن ذلك البؤس الهادر للكرامة الإنسانية، ويكفي أن يكون المرء ناجيًا، لكي يشعر بذلك الخجل من كونه إنسانًا، لأن هناك أصدقاء له لم يتمكنوا من النجاة، ولأن هناك شعبًا كاملًا ما زال يصارع الموت اليومي وضروب القهر ما دون البشري، أملًا بالنجاة. والخجل من كون المرء إنسانًا لا يمكن اختزاله بمشاعر الذنب وتأنيب الضمير التاعس، لأنه لا يقوم على الإحساس بالخطأ ولا طلب المغفرة عن ذنب تم ارتكابه، بل يفيض ازدراء وإدانة للانحطاط البشري المتعين والملموس، وليس هذا أمرًا مجردًا. وبهذا المعنى؛ يكون الخجلُ من كونك إنسانًا شعورًا متعددًا وفكرة غير واحدية، تتحول في هذا السياق إلى دافع للمقاومة، لصناعة المعنى، لرفض المشاركة في هذا الانحطاط، حيث يطالبك الجميع، ولا أحد، بأن تقبل بما يحصل، وكأنه شيء عادي من طبيعة الحياة، وبأن ترى صور الأطفال الغارقين في الوحل والبرد والجوع، ثم تحمد الله على أنك لست أنت، ذلك ما يمكن تسميته بـ “تطبيع الجريمة”، والمطالبة المخفية غير المباشرة، بالمشاركة فيها، حيث إن قبولك بالجريمة كشيء عادي، لمجرد فقدانك للخجل من كونك إنسانًا ضمن تلك الشروط، يحوّلك إلى عبد، وتشارك فعلًا بتطبيع العبودية، تشارك باعتبارك كائنًا بلا قيمة، كائنًا وظيفيًا بيد السلطة التي هزمتك هناك، وتهزمك هنا، وتتابع ترويضك حتى في أحلامك.
لكن هناك ما يجب توضيحه في ما يخص إدانة الجميع وتحميل المسؤولية للجميع، وذلك لكيلا تبقى الإدانة عامة، كلانيّة، ومجردة؛ وبالمحصلة عدمية. فعندما أتّهم “الجميع”، وأقول بمشاركتهم بالجريمة، ليس المقصود أبدًا موازاة المجرم بالضحية، فلسنا جميعًا مجرمين ولا جميعنا قتلة، ولست من أنصار المساواة بالمسؤولية بالطريقة التي لا يكفّ عن طرحها أصحاب الضمير الخاوي، أولئك الذين يلبسون قناع الإنسانوية، لرفع المسؤولية عن الجميع عبر إدانة الجميع بالتساوي، مع بقائهم في موقع الحيادي المتعالي، وهو ما ينتهي بالدعوة “لتبويس الشوارب” و”المصالحة الوطنية”، على الطريقة اللبنانية بعد الحرب الأهلية التي نقلت المجرمين إلى قادة، ومؤداه طبعًا هو نسيان الجريمة الشاملة، وهنا يجدر القول إن تلك النتيجة البائسة هي بالضبط ما يجعل قضية الشعب السوري كلها بلا معنى وبلا دروس مستفادة، بلا معنى إنساني حقيقي لها وبلا معنى سياسي، بلا معنى للمطالب العادلة والمحقة التي خرج الناس للشوارع من أجلها، ولا معنى للجرائم التي ارتكبت بحقهم. ولذلك من الضروري توضيح هذه المسألة الحسّاسة التي تثير الالتباس، وهي أنه لم يعد لدى السوريين كثير من الأوهام حول تحقيق العدالة لما حصل لهم، ليست المسألة محاسبة جميع المجرمين، فهذا أقرب للمستحيل، وليست المسألة جبر الضرر وتعويض الناس الذين فقدوا أبناءهم وبيوتهم وأرزاقهم وأرضهم، فهناك كثير مما لا يمكن تعويضه، وهناك خسارات لا يمكن جبرها ولا إعادتها. المسألة المهمة ضد أولئك الإنسانويين الزائفين وغيرهم هي أن خسارة الماضي الذي لا يمكن تعويضه، لا يجب أن تنتهي بخسارة المستقبل، فنحن لسنا شهودًا على الماضي فحسب، بل شهود على المستقبل أيضًا، ولا شيء يمكن أن يجعلنا أو يدفعنا إلى خسارة المستقبل مثل مساواة الجناة بالضحايا، ولا شيء يجعل من خسارة الماضي نهائية، وخسارة البيوت والأبناء والأرزاق والأعمار أبدية، مثل سلب المعنى من تلك الخسارات، وهو ما يحولها إلى خسارة للمستقبل وللأمل بحياة أفضل للسوريين في بلدهم، وهو أيضًا ما ينقل قضيتهم من قضية تحرّر بين شعب وطاغية، إلى مجرّد حرب أهلية بلا معنى ولا نتائج، أخطأ فيها الجميع بشكل متساوي، وعلى الجميع أن يعودوا إلى الصفر كما بدؤوا، الطاغية مكانه مع إضافة تشكيلة احتلالات جديدة تشاركه الحكم، والشعب مكانه، مع تشكيلة وحوش أخرجتها الحرب من كهوفها لتتناتش بقاياه الباقية، بعد هجرة القادرين على النجاة، وموت المطالبين بالحياة، وحياة المطالبين بالموت كعبء على الحياة.
إن فكرة مساواة الجناة بالضحايا وغفران الجميع للجميع، هي فكرة يتعلق فيها كثير من السوريين وغير السوريين، ملخصها أن النظام لم يعُد وحده الجاني منذ زمن طويل، بل بات الجناة والمجرمون في كل بقعة من أرض سورية: دول وميليشيات وفصائل، إسلاميون خرجوا من قلب الثورة ليأكلوا قلبها، قيادات فاسدة وتابعة وتجار دماء ومعارضات منحطة… إلخ، وكل هذا صحيح، لكنه لا يغيّر شيئًا من معنى القضية السورية؛ وإذا كان لا بدّ من محاسبة جميع المجرمين من جميع الجهات، لكي تبدأ تلك الإمكانية الضرورية فعلًا، فلا بدّ من وجود دولة يمكن من خلالها محاسبة المجرمين، لكن الدولة يسيطر عليها النظام السياسي، الذي لا يعدّ شريكًا في الإجرام مع آخرين فحسب، بل هو الفاعل الأكبر والمتهم الأول بالمسؤولية عن كل ما حدث، وإن كان هناك ما يعوق المحاسبة، أو البدء بمحاسبة المجرمين من كل الأطراف، فهو النظام السياسي الذي يسيطر على الدولة وعلى مؤسساتها.
العالم كله يرى ويعرف ويسمع، وكله يمضي في التطبيع مع الجريمة الحاصلة في سورية، عبر إزاحتها من مشهد الوعي، إدخالها في حيز الشفقة المهين، التلطي خلف تعقيدها الجيوسياسي، نكرانها، وأخيرًا جعلها من طبيعة الحياة الخاصة بنا لا بغيرنا، نحن الوحوش التي تقتل بعضها بلا هدف، وهم المتفرجون على السيرك الدموي من بعيد، لكن ما يسري خلف تطبيع المشهد الدموي المتواصل منذ عشر سنوات، من دون أن يعيره أحد اهتمامًا، هو أن تطبيع الجريمة يتحول تدريجيًا إلى سورنة للعالم، رفع لعتبة الإحساس بالجريمة إلى درجة لا يعود أحد يراها جريمة أصلًا، وتقويض للإحساس بالخطأ في العالم، تطبيع مع القبح والتوحش والطغيان في كل مكان، ليصبح أمرًا عاديًا، بل متوقعًا، وهذا بذاته أمر يدعو للقرف والخجل من أن يكون المرء إنسانًا، بالمعنى الفردي أو المعنى الجماعي.
العالم اليوم كلّه يعرف، ولكن مثلما حصل للشعب الألماني في نكران معسكرات الاعتقال، تحييدها عن الوعي وتجنّب التفكير فيها، ثم التورّط في الإبادة والحل النهائي، ومثلما حصل للسوريين بعد الثمانينيات من معرفة ونكران وتجاوز صامت للمجزرة، وتطبُّع مع وحشية الدولة، ثم التورط في إبادة أوسع كثيرًا من الأولى بعد الثورة، يحصل الآن للعالم أجمع، فالجميع يعرف، والجميع يراوغ ويتجنب وينكر، بحيث يكفي التشكيك لكي يجعل الضمير التاعس مرتاحًا من التفكير بالأمر، لكن غالبًا ما كانت النتائج كارثية في كل التجارب، وهذا التكرار المأساوي على الصعيد الإنساني يدفع أيضًا، بالمعنى الفلسفي والوجودي، إلى الخجل من كون المرء إنسانًا.
[1] بريمو ليفي، إذا كان هذا إنسانًا، ترجمة عماد البغدادي، المشروع القومي للترجمة، الطبعة الأولى عام 2007، ص9-10.
مركز حرمون